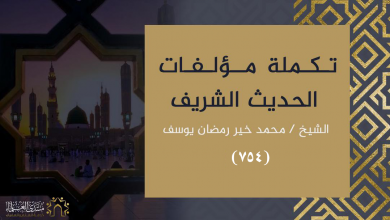إعداد: أحمد بيبني الشنقيطي.
كما قدم الشاطبي نظرية متكاملة عن المقاصد الشرعية، وضمنها قسما خاصا للمرة الأولى في الدراسات الأصولية، وهو ما عبَّر عنه بكتاب المقاصد، فقد قدَّم نظرية متكاملة في أصول الفقه، أي أنه قدَّم أصول الفقه بثوب جديد. وفي الآونة الأخيرة، اشترك الريسوني مع مجموعة من العلماء في كتابة كتاب هو التجديد الأصولي حاولوا أن يقرؤوا هذا العلم قراءة تجديدية مقاصدية . وقد قدَّم الشاطبي هذه القراءة منذ زمن طويل، وبأسلوب الشاطبي الخاص، وقام بأوَّل تجديد حقيقي في أصول الفقه مكتملا وناجزا.
جدد الشاطبي في أصول الفقه، إن على مستوى التصميم والمادة والشكل والمظهر والجسم الخارجي، وإن على مستوى مضمون المادة ومحتواها. وقد حمل كتابه الأسطورة (الموافقات) انتقادات مبطنة لأصول الفقه، تارة بالرمز والإشارة، وتارة باللفظ والعبارة. فلا يذكر القياس بالمعنى المعروف، ويذكره بإضافته إلى الأصول فيعبر عنه بالقياس الأصولي. ويقول عن صيغ العموم التي انشغل الأصوليون بها كثيرا وناقشوا فيها كثيرا: “لا كلام في أن للعموم صيغا وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية”؛ فموقف الشاطبي من هذه الصيغ والتي يستنفذ فيها الجهد الكبير في الكتب الأصولية –(المستصفى) للغزالي مثلا- أن الأصولي لا يبحث في الصيغ، بل يأخذ هذه الصيغ من اللغة العربية كمسلمات ويؤسس عليها، ويبني عليها؛ ولهذا قال الشاطبي –أيضا، وفي ما يشبه قاعدة بأن الأصولي إذا احتاج إلى مسألة نحوية: “فالذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها، في علم النحو فيبنى عليها، فإذا أخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا زائدا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأخذها مسلمة ليفرع عليها في علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا”[1].
ولتأكيد هذه الدعوى العريضة والدفاع عنها، فقد قصدت -في هذا البحث البسيط والمتواضع- أن أتناول لأول مرة -فيما أعلم- أصولَ الفقه عند الشاطبي، وقراءته المقاصدية لهذا العلم. تلك القراءة غير مبتورة، ولكنها تتناول مجمل أو أكثر المواضيع الأصولية، إنما بقراءة متميزة وخلفية أبيستمائية متنورة. وذلك في المطالب التالية:
المطلب الأول: التصميم الذي قدمه الشاطبي لهذا العلم بالمقارنة مع المستصفى نموذجا.
المطلب الثاني: الأصول الإجمالية.
المطلب الثالث: القواعد الأصولية.
المطلب الرابع: الأحكام الشرعية.
المطلب الخامس: الاجتهاد.
المطلب السادس: مميزات أصول الفقه عند الشاطبي والتوصيات.
—————————
المطلب الأول: التصميم الذي قدمه الشاطبي لهذا العلم بالمقارنة مع المستصفى نموذجا:
على مستوى التصميم والغلاف نقارن على سبيل المثال بين المواضيع والتقسيمات الأصولية في (الموافقات) مع أمثالها في (المستصفى). فإنَّ (المستصفى) للغزالي يمثل الصيغة المتطورة لأصول الفقه، عبَّر عن ذلك سالم يفوت بقوله بأنه يمثل: “قمة الكمال، كما يقدم نموذجا في التأليف وحسن الصياغة والعرض والتنظيم للقضايا والموضوعات، تنظيما يحترم التسلسل المنطقي”[2]. وخطته على مستوى التصميم هي التي سار عليها الرازي في (المحصول)، والآمدي في (الإحكام)، وما هما إلا شرحا للمستصفى. فيتكون هذا التصميم أو العرض الشيق من أربعة موضوعات رئيسية سماها أقطابا، فقال: “فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب؛ القطب الأول في الأحكام، والبداءة بها أولى، لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبها التثنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد. وقد أضاف إلى القطب الثاني أدلة سماها بالأصول الموهومة، وهي أربعة أيضا: قول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح، وشرع من قبلنا”[3].
أما الشاطبي فقسم الكتاب حسب الآتي، قال: “فصار كتابا منحصرا في خمسة اقسام: الأول في المقدمات العلمية المحتاج اليها في تمهيد المقصود؛ والثاني في الأحكام وما يتعلق بها، من حيث تصورها والحكم بها أو عليها، كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؛ والثالث في المقاصد الشرعية في الشريعة، وما يتعلق بها من الأحكام؛ والرابع في حصر الأدلة الشرعية، وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها، على الجملة وعلى التفصيل، وذكر مآخذها، وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين؛ والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد، والمتصفين بكل واحد منهما، وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب”[4].
ويحمل الاختلاف في التصميم اختلافا في الأوليات، وبالتالي في المنهجية والرؤية. فقد أضاف الشاطبي إلى الدراسة الأصولية قسمين: أحدهما المقدمات العلمية في تمهيد المقصود؛ وهي مقدمات تضاهي المقدمة المنطقية في (المستصفى)، إلا أن الفرق بينهما واضح، فهذه مقدمات علمية “Sientifiques”، وتلك مقدمة منطقية، وشتان بين من يتحدث عن العلم ومن يتحدث عن الفلسفة والمنطق الصوري. فالغزالي اعتبر العقل حاكما على النقل، وذلك عندما قال بأن المنطق هو سيد العلوم، وخاضعة له، ومن لا يعرفه لا ثقة له في علمه. بينما نلاحظ أن الشاطبي يتحدث عن مقدمات علمية، يقول فيها بالأولوية للنص على العقل، فقال: “الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع”[5].
هناك فرق جوهري وإن كان يأتي في الشكل، وهو قسم المقاصد؛ فهذا لم يسبق أن خصص له موضوع مستقل في الكتابات الأصولية، رغم أن الغزالي اهتم في (شفاء الغليل) بالحديث عن المقاصد وتقسيماتها، وعن المصالح وعن أنواعها.
أما الفرق الشكلي الأخير فهو أنه في قسم الأدلة لم يتحدث إلا عن الكتاب والسنة، ولم يتحدث عن القياس والإجماع، وبالأحرى لم يتحدث عن الأصول الموهومة الأخرى. وأخيرا وليس آخرا نلاحظ فرقا جوهريا، وإن كان أيضا في التصميم والبناء، يتمثل في القواعد الأصولية. فهي عند الغزالي القطب الثالث، وأثنى عليها بقوله: “اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول، لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها، واجتنائها من أغصانها، إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها، والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها، وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها. والمدارك هي الأدلة السمعية، ومرجعها إلى الرسول، إذ منه يسمع الكتاب أيضا، وبه يعرف الإجماع. والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ، وإما فعل، وإما سكوت وتقرير. ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت، لأن الكلام فيهما أوجز. واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو بمعناه ومعقوله، وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا؛ فهذه ثلاثة فنون المنظوم والمفهوم والمعقول”[6]. ويري الغزالي أن البحث في هذا القطب الحساس هو البحث في دلالة اللفظ بحسب منظومه وتصريحه.[7]
بينما ذكرها الشاطبي كمكمل للقسم الرابع، وهو المتعلق بأدلة الأحكام من القرآن والسنة، وذكرها بالإشارة لا بالاسم، وسماها عند التعرض لها بعوارض الأدلة. إنَّ ذلك يحمل نقدا مبطنا لهذه القواعد نظرا للطابع الجدلي فيها كما سيتبين في هذه الأثناء.
أما فيما يتعلق بمميزات وخصائص أصول الفقه عند الشاطبي، على مستوى المضمون والمحتوى والجواهر، فنلمح معه أنه تناول الأصول والمواضيع الأصولية تناولا لا يمتُّ إلى التناول الأصولي لها إلا من جهة التسمية والعناوين، أما المضامين فإن هذه الأصول أخذت صبغة مقاصدية عقلية ذات معنى وتجريبية تطبيقية، بينما هي عند الأصوليين شكلية فراغية. وذلك ما سأتناوله في المطالب التالية.
المطلب الثاني: الأصول الإجمالية:
الأصل الأول: القرآن الكريم:
يتناول الأصوليون مسائل مثل تعريف القرآن، ومسألة البسملة فيه، هل هي آية من كل سورة، أو هي من سورة النحل فقط، وهل هي مع الآية تلوها آية واحدة، ويتناولون هنا في هذا الموضوع تردد الشافعي وقطع القاضي أبي بكر[8]؛ كما يتناولون الكلمات الأجنبية في القرآن، وهذه أمثلة تكفي عن ما وراءها.
أما إذا ذهبنا إلى المخزون الاستراتيجي للمقاصد الشرعية عند الشاطبي، فإننا نلاحظ أن تعامل الشاطبي مع القرآن الكريم لم يحذ فيه حذو الأصوليين، بل تنكب عن مسائلهم ليتناول مسائل أكثر مقاصدية، وأقرب إلى استلهام الأحكام منه. فتحدث عن مقاصد القرآن وطرق معرفة المقاصد فيه.
وهكذا نلاحظ للمرة الأولى أن موضوعات القرآن تجاوزت عدد موضوعات السنة في كتاب (الموافقات)؛ على خلاف مع ما جرت عليه العادة في أصول الفقه. فقد ذكر الشاطبي مسائل القرآن في أربعة عشر مسألة، وذكر مسائل السنة في عشرة مسائل. فالقرآن عند الشاطبي هو أكبر ملهم للمقاصد الشرعية، فهو يقول: “القرآن قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر.. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة، وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن يتخذه سميره وأنيسه”[9].
أما المسألة الثانية فتتعلق بأسباب النزول مصيرا منه إلى أنه ضروري. لأن معرفة مقاصد الكلام تتطلب معرفة أحوال الخطاب وأبعاده، وهي نفس الخطاب والمـُخاطِب والمـُخاطَب. يقول الشاطبي: “معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن”[10].
وخلافا لما ذهب إليه الأصوليون من أن البيان في القرآن قليل لا كثير، وأنه احتوى على العمومات -وهي ظنية في دلالتها، يذهب الشاطبي إلى أن في القرآن البيان لما جاء فيه. وذلك في قوله: “وعلى هذا لا بُدَّ في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه، أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذلك. وإلا فمراتب النظر فيها متعددة، لعلها تذكر بعد في موضعها -إن شاء الله. وقد تقدم في القسم الأول من كتاب الأدلة -قبل هذا- أن كل دليل شرعي فإما مقطوع به أو راجع إلى مقطوع به، وأعلى المقطوع به القرآن الكريم فهو أول مرجوع إليه”[11].
أما المقاصد الشرعية في القرآن فلا شك ولا ريب أن القرآن هو المصدر الأول للمقاصد الشرعية؛ ذلك أنَّ الضروريات والحاجيات والتحسينيات اشتمل عليها، ونبه عليها، وأقام الدليل عليها.
وقد تحدث الشاطبي عن مقاصد القرآن، كما تحدث عن طرق استخراج الأحكام منه، فقال: “إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه، وجاء أيضا ما يقتضي إعماله.. والقول فيه أن الرأي ضربان. أحدهما: جار على موافقة كلام العرب، وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما لأمور، أحدها: أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم. فإما أن يتوقف دون ذلك، فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها، وذلك غير ممكن، فلا بُدَّ من القول فيه بما يليق. والثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- مبينا ذلك كله بالتوقيف؛ فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول. والمعلوم أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل ذلك، فدلَّ على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه، بل بيَّن منه ما لا يوصل إلى علمه، وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم. فلم يلزم في جميع القرآن التوقف. والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد عُلِّم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه؛ والتوقيف ينافي هذا، فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح”.[12]
الأصل الثاني: السنة:
والسنة في الأصول ليست أحسن حالا من القرآن، من حيث دورانها على مواضيع من علم الحديث لا من علم الأصول. قال الغزالي: “اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة، وقسمين: قسم في أخبار التواتر، وقسم في أخبار الآحاد، ويشتمل كل قسم على أبواب”[13]. والموضوعات المطروقة فيهما هي موضوعات في علوم الحديث؛ مثل شروط العدالة، وصفة الراوي، وطرق ثبوت الخبر المتواتر والآحاد. وبعضها يتعلق ببحوث ليست لها نتائج عملية. مثل البحث فيما إذا كان الرسول مجتهدا فيما يصدر عنه من الأحاديث المتضمنة للأحكام؟ ومثل البحث فيما إذا كان متعبدا بشرع سابق؟!
ويظهر ذلك عندما نقارن ذلك بتناول الشاطبي للسنة؛ حيث نلحظ –هناك- الرجوع إلى المنهج الشافعي في البحث في ترتيب العلاقة بينها وبين القرآن من أجل المطالب العملية. ذلك أن تلك العلاقة هي التي تحدد ما سيؤول إليه البحث الشرعي في نهاية المطاف. ففي كتاب (الرسالة) أبواب وفصول عن الدفاع عن سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم، وأنها هي البيان للقرآن الكريم، وقدَّم أمثلة بيان السنة للقرآن حتى يكون البحث علميا. قال الشافعي: “وأيُّ هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله، وأن قد جعل الله بالناس الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله، معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه، ليعلم من عرف هذا، ما وصفنا أن سنته -صلى الله عليه وسلم- إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد، من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاب، فهي كذلك إن كانت، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله بل هو لازم بكل حال”[14]
وقد تناول الشاطبي بشيء من التفصيل هذه العلاقة البيانية، محاولا أن يعيد ترتيب هذه العلاقة، ليكون القرآن المصدر الأول لا في الجواز العقلي فقط، وإنما أيضا في الواقع الفعلي. يقول الشاطبي: “رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار”. ويقول: “فالجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر عنه هو المراد في الكتاب، فكأنَّ السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب. ودل على ذلك قوله: ((لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ))، النحل: 44، فإذا حصل بيان قوله تعالى: ((والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيدِيَهُمَا))، المائدة: 38، بأن القطع من الكوع، وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله، فذلك هو المعنى المراد من الآية. لا أن نقول إنَّ السُّنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب، كما إذا بيَّن لنا مالك -أو غيره من المفسرين- معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه، فلا يصحُّ لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله وقول رسول الله -عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى. فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له، فلا يوقف مع إجماله واحتماله، وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه”[15].
كما اعتنى الشاطبي في السُّنة بالكشف عن حضور المحافظة على المصالح فيها، فقال: “ومنها -أي وجوه بيان السنة للقرآن- النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال، زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح. وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدها دفعا لها. وقد مرَّ أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهي الضروريات، ويليها مكملاتها، والحاجيات، ويضاف إليها مكملاتها، والتحسينيات، ويليها مكملاتها. ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور. فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها، والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب، وبيانا لما فيه منها، فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام”[16]. ويقول أيضا: “فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، فإنَّ حفظ الدين حاصله في ثلاث معان، وهي: الإسلام والإيمان والإحسان، فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء، وهي الدعاء إليه بالترغيب والترهيب، وجهاد من عانده أو رام إفساده، وتلافي النقصان الطارئ في أصله. و أصل هذه في الكتاب، وبيانها في السنة على الكمال”[17].
المطلب الثالث: القواعد الأصولية:
الناسخ والمنسوخ:
لقد أقرَّ علماء الشريعة بوجود النسخ في الشريعة؛ قال الغزالي: “اتفقت الأمة على إطلاق النسخ في الشرع”.[18] وقال عبدالوهاب خلاف: “فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع، ومسايرته المصالح، نسخ بعض الأحكام التي وردت فيهما [يعني القرآن والسنة] ببعض نصوصهما، نسخا كليا أو جزئيا”[19]. وتتفاوت آراء العلماء في عدد الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فهناك من يوسع النسخ ليجعل تخصيص العام وتقييد المطلق نسخا. وهناك من يختصره. وقد عرفه الغزالي بقوله: “الخطاب الدَّال المتقدم على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه”[20].
أما الشاطبي فقال: بأن الشريعة جاءت بالإيمان بالله واليوم الآخر وبمكارم الأخلاق كالعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أصول ومقاصد لا يمكن رفعها. وإذا كان ابن حزم قد قال: اعلم أن نزول المنسوخ بمكة كثير، ونزول الناسخ بالمدينة قليل. فإن الشاطبي يخالفه، ويقول: بأن النزول المدني يكمل النزول المكي ولا يلغيه. كما أن الجزئيات تكمل كلياتها والكليات تحافظ على جزئياتها. ويتمحور موقف الشاطبي في هذا الموضوع برفض النسخ، أو على الأقل التحديد منه إلى أقصى درجة، فهو يقول: “لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية، والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير: لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا، وإن أمكن عقلا. ويدل على ذلك الاستقراء التام؛ وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها، وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي البتة. ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى. فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها والجزئيات المكية قليلة، وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة”.
ويرى الشاطبي أن المقاصد الشرعية التي يجب حمل الأدلة عليها ليس فيها نسخ، فقال: “القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور الجزئية بدليل الاستقراء. فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت، وأن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ. وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس”. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذه المقاصد جاءت المحافظة عليها في الملل الأخرى، وإذا حفظت في تلك الملل كان حفظها والمحافظة عليه في الشريعة أولى. يقول الشاطبي: “فإذا كانت تلك الشرائع قد اتفقت في الأصول مع وقوع النسخ فيها، وثبتت ولم تنسخ، فهي في الملة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولى –والله أعلم”[21].
الأوامر والنواهي:
تمثل الأوامر والنواهي قاعدة لا تقل أهمية عن قاعدة العموم والخصوص. لأنها حسب الرازي هي النظر في الأدلة في ذاتها؛ فقال عن النظر في الأدلة النقلية: “إما أن يكون النظر في ذاتها، وهي الأوامر والنواهي، وإما عوارضها، وإما بحسب متعلقاتها من العموم والخصوص”. ونرى الكثير من الأصوليين يقدمون هذه القاعدة كالسرخسي، الذي قدمها لأنها -حسب رأيه- سبب الابتلاء. وقد تناول الأصوليون هذه القاعدة تناولا إشكاليا، ففصلوا بين الأمر والإرادة، فأدى ذلك إلى أن الأوامر غير مرادة التحقق والنواهي غير مرادة الاجتناب. فقد يأمر الآمر بما لا يريد، ويريد ما لا يأمر به، ومن لم يقتنع بذلك فإن الغزالي يهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل، لأنه لا حل للمسألة بغير ذلك. فقال: “قد يأمر السيد عبده بما لا يريد، كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده، إذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره، فقال له بين يدي الملك: أسرج الدابة؟ وهو يريد أن لا يسرج، إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد، فيعلم أنه لا يريد، وهو أمر، إذ لولاه لما كان العبد مخالفا، ولما تمهد عذره عند السلطان. وكيف لا يكون آمرا وقد فهم العبد والسلطان والحاضرون منه الأمر. فدلَّ أنه يأمر بما لا يريده. هذا منتهي كلامهم، وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم منه ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين، والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الأصول”[22].
كما انشغل الأصوليون بالبحث عن صيغ الأوامر والنواهي. وتحدثوا عن مسائل أخرى قليلة النيل طويلة الذيل. كبحثهم فيما إذا كان الأمر للمرة الواحدة أو للكثرة؛ وفيما إذا كان للفور أم للتراخي. وقد تجاوز الشاطبي هذه المواضيع مصيرا منه إلى أنها خاصة بأهل اللغة، فهم من يقرر الحقيقة فيها، وما توصلوا إليه يأخذه الأصولي كمسلمات.
لقد تناول الشاطبي هذه القاعدة تناولا مقاصديا. فقال بالتلازم بين الأمر والإرادة، ليكتسب الأمر قيمة عملية؛ وذلك بتمييزه بين نوعين من الإرادة، وهما: إرادة التكوين وإرادة التشريع. فقال: “الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر. فالأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه. والنهي يتضمن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه. ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع”.
أما فيما يتعلق بالصيغ اللفظية فهي صالحة للتحديد، ولكن في درجة ثانية، فقال: “الأوامر و النواهي ضربان، صريح وغير صريح. فأمَّا الصريح فله نظران: أحدهما من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية، وهذا نظر من يجري مع مجرد الصيغة مجرى التعبد المحض، من غير تعليل. فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين نهي ونهي، كقوله: أقيموا الصلاة، مع قوله: اكلفوا من العمل مالكم به طاقة؛ وقوله: ((فاسعوا الى ذكر الله))، مع قوله: ((وذروا البيع))؛ وقوله: (ولا تصوموا يوم النحر) مثلا، مع قوله: (لا تواصلوا). وما أشبه ذلك مما يفهم فيه التفرقة بين الأمرين. وهذا نحو ما في الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج على أُبَيِّ بن كعب وهو يصلي، فقال -عليه الصلاة والسلام: يا أُبيَّ؟ فالتفت إليه ولم يجبه، وصلى فخفف ثمَّ انصرف. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: يا أُبَيَّ.. ما منعك ألا تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله كنت أصلي! فقال: أفلم تجد فيما أوحي إلي ((استَجِيبُوا لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحيِيكُم)). قال: بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله.. وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء لمجرد قوله تعالى: ((وذَرُوا البَيعَ))، وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان غيره أرجح منه، وله مجال من النظر منفسح..
والثاني من النظرين هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي، بحسب الاستقراء، وما يقترن به من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات. فإن المفهوم من قوله: ((أقيموا الصلاة)) المحافظة عليها والإدامة لها، ومن قوله: (اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة) الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام للتوجه لله. وكذلك قوله: ((فاسعوا إلى ذكر الله))، مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة، وعدم التفريط فيها، وليس الأمر بالسعي إليها فقط. وقوله: ((وذروا البيع)) جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي، لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا في ذلك الوقت، على حد النهي عن بيع الغرر أو بيع الربا أو نحوهما. وكذلك إذا قال: (لا تصوموا يوم النحر) المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك ايقاع الصوم فيه خصوصا”.
وقد أعطى الأولوية لمقاصد الأدلة لأن ذلك هو شأن الخطاب العربي، فإنما ركبوا الألفاظ للمحافظة على المعاني. وهذا هو مقتضى النظر المقاصدي. قال الشاطبي: “وأيضا فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم. وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع بالاستقراء المعنوي، ولم نستنج فيه لمجرد الصيغة؛ وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة. والنهي كذلك. بل نقول كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزءة. ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو حمار أو جبان كالكلب وفلانة بعيدة مهوى القرط وما لا ينحصر من الأمثلة، لو اعتبر اللفظ لمجرده لم يكن له معنى معقول، فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم”.[23]
العموم و الخصوص:
وهو قاعدة عظيمة من بين القواعد الأصولية. وأرجع الطوفي مباحث علم أصول الفقه إلى العام و الخاص. كما أرجع مباحث أصول الدين إلى قاعدة القدر. فقال: “.. فاعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة، وهي قاعدة القدر، وقد كنت أفردت فيها تأليفا. وفي أصول الفقه قاعدة كذلك، وهي قاعدة العموم والخصوص، وقد كنت عزمت أن أفردها بتأليف، لكن رأيت إدراجها في هذا الإملاء”[24]. وألف القرافي كتابه (العقد المنظوم في الخصوص والعموم). وأشار الجابري إلى أهمية هذا الموضوع فقال: “أبواب العموم والخصوص في دلالة الألفاظ، وهو أكبر أبواب الأبحاث اللغوية الأصولية”[25].
ويتناول الأصوليون هذه القاعدة تناولا نظريا، ويبحثون إشكاليات شكلية، يبدأ الكلام فيها بالاختلاف وينتهي بالاتفاق. ويتطرق الأصوليون في هذه القاعدة إلى مسائل منها: سؤالهم هل العموم من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعاني؟ وهل العرب وضعوا صيغا للعموم؟ وإذا كان الجواب نعم فما هي هذه الصيغ؟ وما عددها؟ ثم ما هو مصير العموم إذا دخله التخصيص؟ هل يبقى حقيقة في الباقي أم يصير مجازا؟ وما هي المخصصات المتصلة والمنفصلة؟ وهل يخصص خبر الواحد عموم القرآن؟ وهل الخطاب العام موجه إلى النساء و العبيد؟ وما هو حكم من سمع العموم ولم يسمع التخصيص؟ وما هو القدر الذي يتوقف عليه الباحث في طلب المخصصات؟
وهذه كلها عناوين وموضوعات لم يرق للشاطبي البحث فيها. فانطلق بما يعارضها، وهو أن العموم هو حقيقة وليس ظنا؛ وأنه من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ. فقال في البداية: “ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص ههنا، والمراد العموم المعنوي كان له صيغة مخصوصة أولا، فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات، أو تحريم الظلم أو غيره، إنه عام فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم؛ بدليل فيه صيغة عموم أولا، بناء على أن الأدلة المستقبلية هنا إنما هي الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم”[26]. وكما رفض أن تكون الأوامر ليست أوامر، رفض أيضا أن تكون العمومات ليست عمومات، فهي كما سيظهر عمومات وقواعد صادقة اليقين. وذلك على شرط أن نجريها حسب مقاصدها التي تتنوع تنوع الخطاب، لا أن نجمد بها على ألفاظ جامدة ومتجمدة.
لقد تناول الأصوليون العمومات باعتبار أن معانيها تتحدد بحسب اللغة، وما كل اللغة بل الدلالة الإفرادية للفظ؛ أما الشاطبي فقد تناول الدلالة التركيبية للفظ، وهو ما سماه بالمقاصد والاستعمال. وراح يدافع عن هذا الموقف، مؤكدا أنه يحمل قراءة جديدة لهذا الموضوع تجعل التساؤل مطروحا، فيما إذا كان علم أصول الفقه كله باطلا؟! لأن القاعدة التي بني عليها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. في هذا الموضوع يرى الشاطبي أن وراء الدلالة اللغوية دلالة مقصدية هي التي يتفاوت الناس في إدراكها، وهي التي تقررت في سور القرآن بحسب تقرير قواعد الشريعة، وهذه الدلالة المقصدية حقيقية لا مجازية.
يرى الأصوليون أن قول الله: ((يا أيها الناس)) وقوله: ((الذين قال لهم الناس)) كل ذلك يعنى العموم، أي جميع الناس، وأوردوا آيتين حملها العرب والصحابة على هذا المعنى للعموم، وهما قوله تعالى: ((إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم))، فقال ابن الزبعري: أنا أخصم لكم محمدا! فقال: فقد عبدت الملائكة والمسيح؟! وقوله تعالى: ((الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم))؛ فقال الصحابة: أيُّنا لم يظلم نفسه؟! فقرر القرآن هذا الفهم، ثم جاء بالتخصيص لاحقا. ويرى الشاطبي أن هذا ليس مبررا. أما اعتراض ابن الزبعري فهو لحداثة سنه وغلبة الهوى عليه، لأنَّ (ما) لما لا يَعقِل، فكيف تشمل الملائكة والمسيح؟! والخطاب –أيضا- موجه للعرب، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح. أما اعتراض الصحابة فذلك عند بداية نزول الإسلام، قبل تقرير قواعد الشريعة؛ وأيضا يوجد منهم الطارئ للإسلام، يقول الشاطبي: “فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره، ويغمض وجه القصد الشرعي فيه، حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال”.[27]
والعمومات ليست ظنية، وإنما هي حقائق صادقة اليقين، أو قواعد صادقة العموم -حسب تعبيره. مثلها في ذلك مثل العمومات اللغوية. وهذه يعرفها علماء اللغة، وتلك يعرفها علماء المقاصد. يقول عن المقصود الشرعي أنه محمول باللغة، لكن لا يعنى معرفته التوقف على علم اللغة، فقال: “وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمنا في كلام العرب، إلا أن له مقاصد تختص به يختص بها العارفون بمقاصد الشارع كما أن الأول [أي الوضع والمقصود العربي] يختص به العارفون بمقاصد العرب”. وعلماء المقاصد الشرعية هدفهم هو: “بيان لعمومات تلك النصوص، كيف وقعت في الشريعة، وأن ثم قصدا آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله، وبه يحصل فهمها، وعلى طريقه يجري سائر العمومات”[28].
وهذا يعنى أن تخصيص العموم لا يعني الإخراج بعد الدخول، بل يعني الكشف عن حقيقة ذلك العموم، وأن ما تناوله أولا هو ما تناوله أخيرا؛ لكن ذلك التناول هو عملية استكشافية وليست معطى لغويا ناجزا.
لقد سبق للطوفي في (الإشارات الإلهية) أن كتب هذا الكلام في العموم. والغرض من ذلك هو قوله: “فنحن إن شاء الله -عز وجل- كلما مررنا بلفظ عام، وجهنا عمومه إن احتاج إلى ذلك، ثم بينا أنه باق على عمومه.. وفي ذلك فوائد جمة كل ذلك بحسب الإمكان -إن شاء الله عز وجل”[29]. وهذا هو موقف الشاطبي من العموم فهو بيان لجهة العموم. يقول الشاطبي بأن التخصيص هو: “بيان فقه الجزئيات من الكليات العامة لا أنه على حقيقة التخصيص عند الأصوليين”.
————————————–
[1] الشاطبي، الموافقات: ج /86.
[2] سالم يفوت، حفريات المعرفة: ص210.
[3] الغزالي، المستصفى: ج2/434.
[4] الشاطبي، الموافقات: ج /9 و10.
[5] الشاطبي، الموافقات: ج1/27.
[6] الغزالي، المستصفى: ص316. ويقول ابن رشد متابعا الغزالي في هذا الموقف: فأما أجزاء هذه الصناعة، بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب، فأربعة أجزاء: فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام, والثاني في أصول الأحكام، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل, وكيف استعمالها، والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه. وأنت تعلم مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة, وفي أي جنس من أجناس العلوم هي داخلة, أن النظر الخاص بها إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب, لأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التي غايتها العمل, ولذلك لقّبوا هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا منها, فدعوها بأصول الفقه. والنظر الصناعي يقتضي أن يفرد القول في هذا الجزء الثالث، إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى”. ابن رشد، الضروري في أصول الفقه: ص36.
[8] الغزالي، المستصفى: ج2/103.
[9] الشاطبي، الموافقات: ج3/200.
[10] المرجع السابق: ج3/201.
[11] المرجع السابق: ج3/221، وما قبلها.
[12] المرجع السابق: ج3/255.
[13] الغزالي، المستصفى: ص105.
[14] الشافعي، الرسالة: ص105.
[15] الشاطبي، الموافقات: ج4/127.
[16] المرجع السابق: ج4/346.
[17] المرجع السابق: ج4/347.
[18] الغزالي، المستصفى: ج2/49- 51.
[19] خلَّاف، علم أصول الفقه: ص222.
[20] الغزالي، المستصفى: ص107؛ والإحكام، للآمدي: ج2/98.
[21] انظر: الموافقات للشاطبي: ج3/63- 71.
[22] الغزالي، المستصفى: ص416.
[23] الشاطبي، الموافقات: ج3/91 وما قبلها.
[24] الطوفي، الإشارات الإلهية: ص214.
[25] الجابري، بنية العقل العربي: ص56.
[26] الشاطبي، الموافقات: ج3/260.
[27] المرجع السابق: ج3/275.
[28] المرجع السابق: ج3/279.
[29] الطوفي، الإشارات الإلهية: ص231- 232.
المصدر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث.