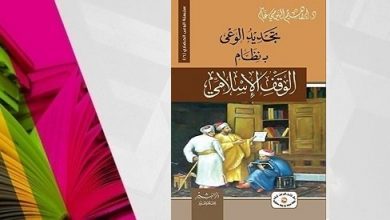تجديد الخطاب الدّيني: مؤامرة متجدّدة لتحريف صحيح العقيدة 4من 6
إعداد د. محمد عبد المحسن مصطفى عبد الرحمن
3.رأي توفيقي بين الإسلام والحضارة الغربيَّة
صدر بحقِّ كتاب من هُنا نبدأ في مايو من عام 1950 ميلاديًّا أمر بالضبط، بناءً على رأي رئيس لجنة الفتوى في الجامع الأزهر، بتهمة التعدِّي على الإسلام علنًا، والترويج لمذهب يرمي إلى تغيير النظم الأساسيَّة للمجتمع، والتحريض على ازدراء فئة مجتمعيَّة، هي فئة الرأسماليِّين. اتَّهمت لجنة الفتوى في الأزهر الكاتب بتشويه صورة السلطة الدينيَّة-التي يصفها بالكهانة-والتي تمارس مهمَّة التصدِّي لأي تحريف لمنهج الله القويم، في ضوء القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهَّرة، من خلال بثِّ أفكار عن تلك السلطة تتهمها بالرجعيَّة من ناحية، وبالحُكم وفق هوى السلطة الحاكمة من ناحية أخرى. كما اتَّهمت لجنة الفتوى الكاتب كذلك بتقليص مهمَّة الدين إلى اعتباره مجرَّد وسيلة للنصح والإرشاد، بلا أيِّ علاقة بينه وبين السلطة؛ على اعتبار أنَّ نبيِّنا مُحمَّد (ﷺ) لم يمارس السلطة في حالات ضروريَّة. وتضم لائحة الاتهام كذلك مطالبة الكاتب بإيقاف إقامة الحدود؛ لما لتطبيقها من تأثير منفِّر من الدين، مثل إقامة حدِّ السرقة بقطع اليد. ومن بين الاتهامات كذلك التنفير من فرض الزكاة، التي يرى في إعطائها الفقراء إذلالًا، مناديًا بتطبيق الاشتراكيَّة، التي تكفل للشعب كلِّه حياة كريمة.
أُخذ على الكاتب كذلك اتهامه السلطة الدينيَّة في الدولة بالحُكم تبعًا لهواها، وليس الكتاب والسُّنَّة، وبتفسير الآيات وفق هوى النفس، وليس الأمر الإلهي. وكذلك أُخذ عليه رفضه الحكومة الدينيَّة للدولة؛ على اعتبار أنَّ استغلال الدين في حُكم الشعوب يُحدث صدعًا في العلاقة بين الدين والبشر؛ بأن يصير الدين سيفًا يقطع الرقاب وفق مصلحة الحاكم، بينما هو موجود لتحسين أحوال الناس. ويضيف الكاتب إلى أسباب رفضه للدولة الدينيَّة أنَّ دعوة الدين في جوهرها تستهدف التوحيد، والعدالة، والمساواة، والإخاء بين البشر، فما الحاجة إلى تأسيس دولة دينيَّة إن كانت تلك فحسب هي أهداف الدين؟
ويفرِّق الكاتب كذلك بين الدين والدعاة إليه؛ فالدين منزَّل من عند الله، ولكن الدعاة بشر يصيبون ويخطؤون، ويحكمون بحسب الهوى-إن استدعى الأمر. وفي نفس هذا السياق، يشير الكاتب إلى استغلال المعاني المختلفة التي تعكسها الآيات القرآنيَّة والأحاديث الشريفة، مستشهدًا بذلك بقول الإمام علي “القرآن حمَّال أوجه”، وقول الصحابي عبد الله بن عبَّاس “القرآن ذلول ذو وجوه؛ فاحملوه على أحسن وجوهه”، إلى أقوال مشابهة لمفسِّري القرآن الكريم. وكان ردُّ الكاتب على المطالبين بحكومة دينيَّة تقيم العدل وتمحي الرذائل، بأنَّ التطهر من الآثام لا بدَّ وأن يكون من الداخل، وليس بفعل سلطة خارجيَّة تنفيذيَّة؛ لأنَّ الرغبة في البعد عن الآثام إن لم تنبع من الداخل، سيجد الناس وسائل أخرى عديدة لممارسة الرذائل، وحينها سيشتد العداء بين الدين، الذي سيصف سفًا فوق الرقاب، والبشر، الذين سيرون الدين وسيلة تهديد وإرهاب.
يدعو الكاتب إلى العدالة في توزيع الفرص والثروات بين الناس؛ للحد من الفوارق الاجتماعيَّة ورأب الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء. والسبيل إلى ذلك هو تطبيق قيم اشتراكيَّة تضمن العدالة الاجتماعيَّة، وتحدُّ من سطوة طاغوت الرأسماليَّة، دون محوها بالكامل. فما هو السبيل للخروج من أزمة انتشار الفقر، وانخفاض أجور العمَّال، وتفشِّي الأمراض والأميَّة؟ ولم تجد رئاسة محكمة القاهرة الابتدائيَّة فيما قاله الكاتب ما يتعرَّض لصحيح الدين بالافتراء أو الطعن؛ ومن ثمَّ، أمر رئيس المحكمة بإلغاء قرار ضبط الكتاب، استنادًا إلى أنَّ “حريَّة الرأي مكفولة في حدود القانون” وأنَّ “الكتاب لا ينطوي على جريمة ما”.
يبدأ خالد محمَّد خالد كتابه بالإشارة إلى حكمة يؤمن بها، هي “الاستبداد هو الأب الشرعي للمقاومة”، لافتًا إلى أنَّ الطريق إلى تكوين “حضارة خصيبة” مثمرة تقضي على التخلُّف والعبوديَّة هو “فتح منافذ الملاحة الفكريَّة، والقضاء على كلِّ بواعث التهيُّب في الشعب”؛ ويضيف الكاتب حكمة أخرى، هي “إذا أساء الشعب ممارسة حريَّته، ومارس حقَّه فيها ممارسة طاغية، فقد وقَّع وثيقة عبوديَّته، وأتاح للحكومة فرصة وضعه تحت الوصاية من جديد” (ص43). أمَّا عن السبب من الإشارة إلى ذلك، فهو رغبة الكاتب في تنقية الأذهان والقضاء على أسباب التخلُّف في سبيل اللحاق بركب التقدُّم. أراد الكاتب بثَّ الوعي، في مرحلة اختلطت فيها الآراء، وصعُب على الناس التمييز بين السُبُل لاختيار الأجدر بالاتِّخاذ. ويتولَّى الكاتب مهمَّة التمييز بين الحقِّ والباطل، وفق الفكر الذي اتَّبعه ورآه الأصح؛ لأنَّ ذلك “هو السبيل، كلُّ السبيل، إلى خلْق المجتمع الحرِّ الباسل الذي نريد أن نكونه” (ص44). يدعو الكاتب إلى “تحوُّل اجتماعي وديع يفضي بنا إلى قوميَّة شاملة لا تنافُر فيها، وإلى اشتراكيَّة عادلة ولا استغلال ولا ظلم فيها، وإلى وعي ناضج سليم لا سلطان للرجعيَّة ولا للكهانة عليه، وإلى سلام غامر يبدِّل حقد المجتمع حبًّا، وتربُّصه ولاءً وأمنًا، وقلقه استقرارًا وغبطة” (ص46).
عندما يكون الدين عقبة في طريق التحرُّر والتقدُّم، ومانعًا دون الحقوق، تصبح علاقة الشعوب به علاقة تنافُر، وليس تجاذُب. ويرى الكاتب أنَّ استمرار الولاء للدين-وبالتالي الخضوع له-يعتمد على أمرين أساسيِّين: الأوَّل قدرته على التفاعل مع حاجات البشريَّة، دون إظهار أيِّ عجز في أي حين من الزمن؛ “حتى تستطيع البشريَّة أن تجد منه عونًا دائمًا يمكنِّها من مواجهة مشاكلها المستحدثة، وضروراتها الطارئة، ويبارك محاولاتها المستمرة للتقدم والوثوب” (ص49). أمَّا الثاني، فهو عدم حياده عن الهدف الذي وُجد لأجله، وهو إسعاد البشريَّة وتحقيق العدالة والمساواة، وليس تنظيم حياتهم.
بدأ الكاتب يحذِّر مما أطلق عليه “الكهانة”، قاصدًا السلطة الدينيَّة، التي سعت منذ قرون إلى السيطرة على حياة البشر، من خلال استغلال تقيُّدهم بالدين، “مباركةً الرجعيَّة الاقتصاديَّة والرجعيَّة الاجتماعيَّة، مدافعة عن مزايا الفقر والجهل والمرض” (ص50). ولا يجد الكاتب حرجًا في دعوة الحكومات والمجتمعات إلى التخلُّص من كلِّ صور الكهانة، التي شوَّهت علاقة البشر بدينهم، وأدخلت على الدين ما ليس فيه، داعيًا إلى العودة إلى صحيح الدين، وبثِّ تعاليمه الصحيحة. ما يقصده الكاتب هو أنَّ رسالة الله الحقيقيَّة هناك من أساء نقلها للناس، فاستغلَّها لتحقيق مصالحه الفرديَّة. ولأنَّ في نشر العلم والوعي الصحيحين ما يعطِّل مساعي هؤلاء للسيطرة على السلطة باسم الدين، يعارض “الكهنة” أيِّ فِكر تنويري، وإن كان في نشر الفكر التنويري تحقيق للتقدم والمدنيَّة. يعني ذلك أنَّ الحداثة هي عدو تجَّار الدين؛ لأنَّ في تطبيقها إنهاء لممارساتهم الباطلة باسم الدين.
يستنكر الكاتب موقف رجال الدين من الحداثة بعد الحرب العالميَّة الثانية، حينما بدأت الدول الأوروبيَّة إعادة بناء نفسها، وتبنِّي أفكار تقدميَّة للقضاء على التخلُّف والرجعيَّة، بينما انخرط رجال الدين في الوعظ بأهميَّة القيم الدينيَّة، والثبات على المبدأ، والصبر في البأساء والضرَّاء، بل والترويج لأنَّ الرسول ذاته اعتبر أنَّ الفقر من سمات الملتزمين بصحيح الدين؛ فقد روى الترمذي، في حديث حسن صحيح، أنَّ رجلًا جاء النبي، فقال “وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” انْظُرْ مَا تَقُولُ ” ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : “إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا ، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ”. ويرفض الكاتب التسليم بذلك، معتبرًا أنَّ الحضِّ على الرضا بالفقر تخاذُل. علاوة على ذلك، يسخر الكاتب من استنكار أحد الأزهريِّين مطالبة أقرانه بتحسين أوضاعهم الماديَّة بأن قال (الأزهري) “إنَّه ليحزننا اهتمام الأزهريِّين بالأرزاق والدرجات، إنَّ العلم والدنيا لا يجتمعان في قلب واحد، فليختر الأزهريُّون لأنفسهم إمَّا العلم وإمَّا الدنيا”. الأكثر من ذلك أنَّ الكاتب يعتبر أنَّ دعوة علماء الأزهر الجماهير إلى الصبر على الأوضاع الاقتصاديَّة مؤامرة اشتركوا فيها مع النظام الحاكم لصرف أصحاب الحقوق عن المطالبة بحقوقهم.
يُطلق الكاتب على نظام الزكاة الذي وضعه الإسلام “اشتراكيَّة الصدقات”، ويراها امتدادًا لفكرة وثنيَّة عمل الكهنة من خلالها على إجبار البسطاء من المزارعين على إعطاء جزء من محاصيلهم للمعابد، على اعتبار أنَّ الأرض التي يزرعونها هي في الأساس للربِّ. يقول الكاتب “فالصدقة في نظر الكهانة نظام اقتصادي وافٍ! ووسيلة ناجحة لمحاربة الفقر وإسعاد الشعب ومطاردة متاعبه وشقائه، وإنَّك لتسمع وترى الدعوة إلى الصدقة في كلِّ مناسبة حتى لتكاد تشكُّ: هل أنتَ في مجتمع أم في ملجأ!” (ص57). ويضيف خالد أنَّ الله تعالى لم يعتبر الصدقة نظامًا للعدالة والتكافل الاجتماعي في حدِّ ذاته، ولا وسيلة للنهضة والارتقاء، مشبِّهًا إيَّاها بـ “أكل الميتة” (ص58). ويستشهد الكاتب في ذلك بحديث رواه الإمام مُسلم، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله (ﷺ) “إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس”. وردًّا على هذا الزعم، يوضح الدكتور خالد المُصلح، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة القصيم، في مقطع نشره على صفحته على يوتيوب، أنَّ المقصود بالحديث أنَّ الصدقة تطهِّر أعمال مخرجيها من الآثام، أو لتقل الأعمال الدنسة، والتي يُشار إليها بـ “أوساخ الناس”. أمَّا المال نفسه فهو حلال تزكِّيه الصدقة من السوء، استنادًا إلى قوله تعالى في الآية 103 من سورة التوبة “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا”.
يستمر الكاتب في انتقاده اللاذع للمؤسَّسة الدينيَّة، متهمًا إيَّاه بتشريع البقاء على العوز والنفور من سُبُل النهوض، من خلال نشر “فلسفة كهنوتيَّة كئيبة” تدعو العالم الإسلامي وحده إلى “نبذ المادَّة المضللة، والاعتصام بالروحانيَّة” (ص61). وبرغم إطلاقه على علماء الدين مُسمَّى “الغافلون النافعون”، فهو يعترف بإخلاصهم لثوابت الدين، وصدق دعواهم؛ إلَّا أنَّه لا يطمئن لطبيعة تفكيرهم، المفتقر إلى الرؤية العميقة، والمستغرق في الرجعيَّة. ويقول بالنصِّ في ذلك “الرجعي الذي يعمل على تعويق التطوُّر والحضارة، ويعمل على أن تبقى النظم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة في الشعب كالمومياء المحنَّطة لا تدب الحياة فيها، ولا يجري في عروقها دمٌ جديدٌ، مغفَّل نافع للاستعمار والجهل” (ص62).
يتناول الكاتب مسألة الروحانيَّة من منظور رجال السلطة الدينيَّة، ويعتبرها مخدِّر استُخدم لتخدير الشعوب وإلهائها عن المطالبة بحقوقها. ولعدم الخالط، لا يقصد خالد بالروحانيَّة التنقية الروحيَّة من خلال جلسات التأمُّل والتدبُّر والذِّكر للحصول على الإلهام، أو “إطلاق البخور، وتلاوة الرقى، ومخاطبة الجان، واستحضار الأرواح”، إنَّما يشير إلى مفهومين لها: الأوَّل هو نبذ المُتع الدنيويَّة والابتعاد عن مباهج الحياة؛ أمَّا الثاني، فهو التركيز على الفضائل المعنويَّة والنفسيَّة التي ترقِّي في المرء العوامل الإيجابيَّة، من تسامُح ومحبَّة وإيثار (ص65). ويعترض الكاتب على هذا السلوك المحرِّض على السكوت عن الحقِّ، معتبرًا أن عصر الزُّهد قد ولَّى، ومضيفًا أنَّ توصية الرسول بعدم الافتتان بمُتع الدنيا “((توجيهات استثنائيَّة)) لظروف استثنائيَّة” (ص66). ويتساءل الكاتب “أليست الروحانيَّة تعني السلام والإخاء والمحبَّة؟ وكيف السبيل إليها في جماعة يؤجِّج الحرمان في أنفسهم نار البغضاء والحقد والتشاؤم من الحياة وأهلها!” (ص69).
ويستعرض خالد محمَّد خالد مفهومه عن الروحانيَّة، مستشهدًا بقول المستشرقة “الفاضلة” كاترين هنري، الذي يقول أنَّ الإنسان “مفتقر دائمًا إلى الوحي والإلهام في حياته الفرديَّة والاجتماعيَّة. والروحانيَّة هي التي تكمل النقص من هذه الناحية، وتُطلق القوى الكامنة في طبيعة الإنسان من عقالها، وتوجهها إلى متجهات في الحياة نحو الله، ونحو محبَّة الإنسان وخدمته” (ص71). الروحانيَّة من منظور الكاتب تفتح الأفق والمدارك، وتمدُّ الإنسان بمعرفة بالمجهول، وتكشف له عن الغوامض؛ وتلك الروحانيَّة هي سرُّ العبقريَّة وبداية الابتكار من خلال “تلك الإلهامات التي تومضها فينا أحيانًا، والتي أومضتها في نفوس العباقرة والمخترعين، فكانت تلك الحضارة العتيدة” (ص71). ويستتبع الرخاء الاقتصادي، وسدُّ الحاجات، وتوفير الرعاية الاجتماعيَّة السليمة هذا “الإشراق الروحي”، وبعد ذلك تحدث النهضة الحضاريَّة المرجوَّة، ولا سبيل لتلك النهضة سوى ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنَّ استخدام مُصطلح “الكهنة” في وصف رجال الدين يستمدُّه الكاتب من وصف المفكِّر والمؤلِّف البريطاني إتش جي ويلز لهم في كتاباته. ويتأثَّر خالد محمَّد خالد كثيرًا بأفكار ويلز، المعروف بكتاباته المبكِّرة عن الحداثة وطبيعة تفاعُل الأمم معها في المستقبل، حيث كَتَب عن ذلك منذ مطلع القرن العشرين. يتميَّز ويلز بكتابته في مجال الخيال العلمي، وبتناوله المستقبليَّات؛ ومن بين الأفكار التي تعرَّض لها ضرورة تحرير العقل من القيود البالية، التي لا تناسُب زمن الحداثة، و”ارتشاف العرفان…على أيدي الكهنة”، الذين يعتبر ويلز كثيرًا منهم “أغبياء، متمسِّكين بالمبادئ النظريَّة، وقد أعمى تمسًّكهم الجامد بالتقاليد بصائرهم” (ص73). من جديد، يؤكِّد خالد أنَّ عقليَّة رجال الدين المتحجِّرة هي التي تعمل على الإبقاء على الرجعيَّة؛ لأنَّ في نشر التنوير الذهني تهديد لمصالحهم الشخصيَّة. تحتكر أفكار السلطة الدينيَّة العقل، وتجد العقل الحرَّ تهديدًا لمستقبلها؛ على عكس الدين، الذي “يدعو لإضاءة الأنوار، ويعلن سُلطان العقل أيَّما إعلان، ويدعوه إلى اقتحام كلِّ مناطق الفكر دون أن يخاف أو يخشى” (ص74).
يتطرَّق خالد محمَّد خالد إلى مسألة تحرُّر الغرب من قيود الكنيسة، بعد أن أراقوا دماء علماء ومفكِّرين بسبب أفكارهم المعادية لتعاليم الكنيسة. فقد اتَّهمت الكنيسة جاليليو بالإلحاد، وقبله سجنت كوبرنيكوس؛ لكنَّ التقييد العقلي انتهى اليوم، وبقيت إسهامات هؤلاء العلماء. ويدعو الكاتب أقطاب السلطة الدينيَّة إلى اليأس من محاولاتهم لتغييب العقول؛ لأنَّها محكوم عليها بالفشل، معتبرًا أنَّ “الكهانة تتوسَّل بالمسجد والمنبر لتقويض المجتمع”، وأنَّها “تحارب العقل لأنَّه يُري الناس عوراتهم، ويبدي لهم سوءاتها، ويعمل جادًّا لفضِّ سوقها…هي تخشاه لأنَّها لا تصبر على بحث، ولا تصمد أمام نقدٍ. أمَّا الدين الصحيح، فيعلم أنَّ العقل صديقه الوحيد، الذي يهيئ له النفوس، ويمكِّن له في القلوب” (ص77). ويستشهد الكاتب في ذلك بحديث الرسول (ﷺ) إلى الصحابي حذيفة بن اليمان “يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا”، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: ” هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا”. أي أنَّ “الدُّعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ” الذين يقصدهم خالد محمَّد خالد هم الذين يحاربون الجانب الروحاني في العبادة، ويستغنون عن تطبيق الفلسفات الغربيَّة المُستمدَّة من العقائد الوثنيَّة، ويلتزمون بصحيح الكتاب والسُّنَّة؛ هؤلاء من منكري البدع والمُحدثات هم يهدون النَّاس إلى جَهَنَّمَ، ومن استجاب لهم وطبَّق أفكارهم المعادية للفكر الحداثي “قَذَفُوهُ فِيهَا”.
يستعرض الكاتب لاحقًا الفرق بين الدين وبين الكهانة، معتبرًا أنَّ أهم الفروق هو إنسانيَّة الدين وأنانيَّة الكهانة. سخَّر الله الكون لخدمة الإنسان، وأمره بالسعي في مناكب الأرض وطلب الرزق، لكنَّ الكهانة جاءت لتوقع الإنسان تحت سطوة قيود تحرمه من حقوقه في العيش، فقط من أجل تحقيق مصالح فئة محدودة منتفعة من خلال أفكار مغلوطة ليست من عند الله، إنَّما من الشيطان؛ فالكهنة “أسهموا في خلق طبقة ((رقيق الأرض))، واسترقُّوا الجماهير الكادحة لحسابهم، وحساب الإقطاعيِّين”، حتَّى جاء الدين وخلَّص البشر من تلك القيود (ص83). ويستشهد الكاتب في ذلك بقصَّة نبي الله موسى مع فرعون، كما وردت في سورة الدخان “وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18)”.
وتشكَّل الديموقراطيَّة الفرق الثاني بين الدين والكهانة؛ فالدين أزال الفوارق بين البشر، ولم يفرِّق بين عربي وأعجمي إلَّا بالتقوى، كما أمر بعد استعباد الناس، الذين ولدتهم أمَّهاتهم أحرارًا. أمَّا الكهانة، فهي تشدِّد على أهميَّة الفوارق الاجتماعيَّة، وتُبقي فئة معيَّنة، تضيِّق عليها في المعيشة، في أدنى مراتب المجتمع؛ لتضمن لنفسها الصدارة ولترسِّخ لبقائها في الواجهة؛ فقد اعتاد الكهنة على “أن ينحني لهم الناس، ويخرُّوا على أيديهم سُجَّدًا ثمَّ يشبعوها لثمًا وتقبيلًا…وكذلك تعوَّدوا أن يأمروا فيُطاعوا لأنَّهم أبناء السماء، أو أبناء الهيكل…والويل لمن يقول لشيخه أو كاهنه: لمَ؟” (ص84). يعتبر الله تعالى البشر سواسية، بينما تطالب الكهانة بـ “خلافة دينيَّة وحكومة دينيَّة”، تضع على رأس الناس من يستعبدهم، ويسيطر عليهم (ص85).
أمَّا الفرق الثالث، فهو اعتماد الإيمان الديني على العقل، بينما تُخرجه الكهانة من حساباتها بالمرَّة. يستشهد الكاتب في ذلك برأي أئمة أهل السُّنَّة عن ضرورة إعمال العقل، واستنادهم إليه في استصدار الفتاوى والأحكام؛ أمَّا الكهانة، فهي تبثُّ المخاوف في النفوس من محاولة فهْم الحقيقة، وتُرهب كلَّ من يحاول الانتصار للحقِّ، واتِّخاذ المنهج الديني القويم. يثري الدين الحياة ويعد بالفوز بالنعيم في الآخرة؛ أمَّا الكهانة، فهي لا تُذكِّر الإنسان إلَّا بالموت، وبالتراب الذي خُلق الإنسان منه، وسيعود إليه. ومن هنا، ينتقل الكاتب إلى الفرق الرابع بين الدين والكهانة، وهو النظرة الدينيَّة المتفائلة للحياة، وتشجيعه على العمل لتحقيق الذات، والارتقاء بالأمم، وهذا ما لا تريده الكهانة. يتطوَّر الدين في خطوات منتظمة، بينما تبقى الكهانة على حالها.
ولإيقاف نشر الوعي الديني الزائف، ينصح الكاتب بإعداد جيل من الخطباء والوعَّاظ الجدد، يمتلك القدرة على الإقناع وفق مناهج سليمة نابعة من “الوعي الجديد”؛ كما ينصح الدولة بتأسيس جامعة، أو حتَّى كليَّة، لتدريس العلوم الإسلاميَّة الحقَّة، والمبادئ الدينيَّة الصحيحة؛ فيتخرَّج فيها “وعَّاظ من طراز جديد…كوعَّاظ الكنيسة في أوروبا” (ص91). ويقترح الكاتب كذلك قصر صلاة الجمعة على المساجد الكبيرة في كلِّ حيٍّ، مع انتقاء الثقافة الموجَّهة إلى المصلِّين على أفضل وجه بما يحقِّق النفع، ويضمن الارتقاء بالأمَّة؛ “فتنسخ بذلك آيات الكهانة، وتحكم آيات الله وآيات الحضارة” (ص94). ولم ينسَ الكاتب النصح بإصلاح الكنيسة، قائلًا “لا بدَّ من أن تنتظم الكنيسة أيضًا-فيؤلَّف من بين رجالها الراشدين من يشرفون على توجيه رسالتها توجيهًا يخلق الشعب الذي يحيا بالدين، ولا يموت” (ص94).
يتطرَّق الكاتب إلى نقطة في غاية الحساسيَّة، وهي نجاح الغرب في تجاوُز محنة الحرب العالميَّة الثانية، التي عاصرها، وتحقيقه إنجازات هامَّة غيَّرت مجرى حياته، وضاعفت من سطوته. على سبيل المثال، نجحت حكومة حزب العمَّال في بريطانيا، والتي أمسكت بزمام الأمور في أعقاب الحرب مباشرةً، في حلِّ مشكلات البطالة والفوضى؛ بفضل تطبيق مبادئ الاشتراكيَّة على أتمِّ وجه. نجحت تلك الحكومة في تحقيق أهمِّ شرط للاستقرار، سدِّ جوع الشعب وإيواء المشرَّدين منه. لم يلفت الكاتب إلى أنَّ حكومة حزب العمَّال لم تنجح في إكمال مسيرتها، وأنَّها لم تُفلح في التغلُّب على مشكلات واجهتها لاحقًا. ويشير الكاتب كذلك إلى حرص الولايات المتَّحدة على إعانة البلدان الفقيرة، ولكن مع انتقاء المستحق من تلك البلدان، فالتي تقع منها تحت حُكم استبدادي إقطاعي لا يستحقُّ شعبها أيَّة موارد للإعانة.
يعتقد الكاتب أنَّ السبيل الوحيد لإحلال السلام في العالم الإسلامي هو سدُّ احتياجات بنيه، ولا يمكن ذلك إلَّا من خلال إصلاح داخلي، إعمالًا بقوله تعالى “إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ” (سورة الرعد: الآية 11). ويستشهد الكاتب على رأيه بأنَّ الجوع هو شرارة أيِّ ثورة أو اضطراب داخلي يعيق التنمية بقول العالم الزراعي البريطاني سيرجون لويدأور خلال مؤتمر الشعوب المتَّحدة للغذاء والزراعة عام 1948 “إنَّ الجوع وارتفاع الأسعار يقودان دائمًا إلى الثورات الاجتماعيَّة، ونحن نذكر أنَّ عجز المحاصيل في فرنسا عام 1840…كانت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وندرة الحصول عليه…وكان الشعب في شمالي إنجلترا يهزج ويصيح: استلُّوا خناجركم، وأعدُّوا مدافعكم، فإمَّا الرغيف وإمَّا الدماء، وإمَّا الحياة وإمَّا الفناء” (ص103). يستتبع انتشار الفقر، مع وجود ثراء فاحش يستأثر به فئة محدودة من الشعب على حساب الفقراء، حالة من “التذمُّر النامي المتراكم” يعدُّ “من أخطر الأشياء على حياة الأمَّة، ولا يمكن أن يستهين بعاقبته، أو يسكت عن علاجه، حاكمٌ له بصر بالأمور” (ص104). ويحذِّر الكاتب من انتشار الجريمة في المجتمعات المسلمة بسبب الفقر وتفشِّي الحقد الطبقي، بل ويستشهد في ذلك بقول الصحابي أبي ذر الغفاري “عجبتُ لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرًا سيفه” (ص110).
يتناول خالد بعد ذلك مسألة المفاضلة بين الحكومتين القوميَّة والدينيَّة، رافضًا الثانية بالكليَّة، ومعتبرًا عودتها خطوة إلى الخلف؛ بسبب فشلها السابق، وعجزها عن توفير الحريَّة الرأي. يجد الكاتب في الحكومة الدينيَّة “تجربة فاشلة”، ويرى عودتها “انتكاسًا إلى الأوتوقراطيَّة المرهقة، التي تخلَّصت منها الإنسانيَّة بمشقَّة وكَبَدٍ”، والأكثر من ذلك أنَّه يجدها خطرًا على الدين ذاته؛ فهي “مجازفة بالدين ذاته مجازفة تعرِّض نقاوته للكدر، وسلامته للخطر” (ص169). ويتساءل الكاتب “أنمضي قُدُمًا، أم ننتكس إلى الوراء؟ أننحرف عن قوميَّة الحُكم إلى عنصريَّته وطائفيَّته، أم نضاعف هذه القوميَّة وننميها؟ أنفرُّ من عصر حريَّة الفكر وحريَّة القول وحريَّة النقد-مهما كان ضئيلًا-إلى عهد من إذا قال للأمير لمَ؟ فقد حلَّ دمه وبرئت منه ذمَّة الله؟” (ص170). يضرب الكاتب المثل في ذلك بثورة المسيحيِّين على المسيحيَّة، عندما “حوَّلتها الكنيسة إلى دولة وسلطان، واقترفت باسمها أشدَّ أصناف البغي والقسوة” (ص171).
يجتهد الكاتب في تحليل سيكولوجيَّة الحكومة الدينيَّة، في محاولة للوقوف على العوامل المؤثِّرة في اتِّخاذها القرارات والمسارات، ويسبق تحليلَه رأيُه بأنَّ الحكومة الدينيَّة “في تسع وتسعين في المائة من حالاتها جحيم وفوضى” و”إحدى المؤسسات التاريخيَّة التي استنفدت أغراضها، ولم يعد لها في التاريخ دور تؤدِّيه” (ص174). يرى خالد في الحكومة الدينيَّة عودة إلى الجاهليَّة، حينما كانت هناك فئة ضئيلة صاحبة سيادة وقوَّة يخضع لها باقي العباد؛ وفي هذا ما يتعارض مع صحيح الإسلام-وفق رأيه-الذي يحضُّ على المساواة والعدالة في تقسيم الفرص. يستند الكاتب في ذلك إلى الحديث المروي عن رسولنا الكريم (ﷺ)، حينما دخل عليه دخل عمر، وقد رأى الحصير قد أثَّر على جنبه فبكى، وقال “يا رسول الله كسرى، وهما يعصيان الله، ينامان في الديباج والحرير وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك” فردَّ الرسول الكريم: “أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله. فقال رسول الله (ﷺ): ” إنَّها نبوة لا ملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر”. يعمل الكاتب بعد ذلك على نفي أي زعامة سياسيَّة للرسول خارج إطار المعاهدات وإدارة الأمور الملحَّة، مشيرًا إلى أنَّ-وفق قراءته لسيرة الرسول-لم يجد ما يوحي بأنَّه كان أميرًا أو حاكمًا بالمعنى المعروف.
وبناءً على ما توصَّل إليه الكاتب من استنتاج بشأن طبيعة مركز الرسول في الأمَّة، وتكوينه رأيًا يجد أنَّ زعامة الرسول الدينيَّة كانت الطاغية على ممارسته السياسة أو الحكم أو القيادة العسكريَّة، يتساءل الكاتب “ما حاجة الدين إذن إلى أن يكون دولة؟ …وكيف يمكن أن يكونها، وهو عبارة عن حقائق خالدة لا تتغيَّر، بينما الدولة نظمٌ تخضع لعوامل التطوُّر، والترقِّي المستمر، والتبدُّل الدائم؟ وهل الدين أدنى مرتبة من الدولة حتَّى يتحوَّل إليها، ويندمج بها؟ ثمَّ إنَّ الدولة بنظمها الدائبة التغيير عرضة للنقد والتجريح، وعرضةً للسقوط والهزائم والاستعمار، فكيف نعرِّض الدين لهذه المهاب أو بعضها؟” (ص180).
يعتبر الكاتب ألَّا دخلَ لسلطة الدولة في ترويض السلوكيَّات الطائشة؛ لأنَّ هذه هي وظيفة الدين في الإرشاد إلى الطريق القويم، ولكن هل يُفلح الإرشاد إذا كان الإنسان لم يعمل على تطهير ذاته، أو ينبع الميل إلى الصلاح من داخله؟ يضيف الكاتب أنَّ حدَّ السرقة لا يمكن العمل به، طالما ينتشر الفقر في العالم الإسلامي: “الشرق الإسلامي كلُّه مجاعات، مادام الناس لم يستوفوا فيه ضرورات الحياة…إذن فحدُّ السرقة موقوف حتَّى ينزل الرخاء مكان الجدب…ويوم يوجد الرخاء، فلن تجد السارقين…وإن وجدتهم، فاقطع منهم كلَّ معصم وساق” (ص182).
إذا كان الدين يسرٌ، وكان التسامح سمة أساسيَّة فيه، فليس من الممكن اعتبار سلوكيَّات “الدولة الدينيَّة” من الإسلام في شيء. فالحكومة الدينيَّة “لا تستلهم مبادئها وسلوكها من كتاب الله ولا من سُنَّة رسوله، بل من نفسيَّة الحاكمين وأطماعهم ومنافعهم الذاتيَّة، ومن تلك الغرائز التي تصدر عنها” (ص186). ويعتبر الكاتب الغموض المطلق أبرز سمات الدولة الدينيَّة، حيث تقوم تلك الدولة على سطلة عمياء، تستلزم “الطاعة العمياء والتفويض المطلق”؛ لأنَّها تعتقد أنَّها “ظلُّ الله على الأرض” (ص186). وكلَّما طُلب من تلك السلطة تفسير الغموض المحيط بسياساتها، فهي تستغلُّ الدين لصالحها، من خلال استخدام الآيات والأحاديث لتعكس المعنى الذي يخدم المصلحة. ويضرب الكاتب في ذلك المثل بقصَّة يزيد بن معاوية-الفاسق، مدمن الخمر-حينما خطب في الناس لتحريضهم ضدَّ الحسين، مستشهدًا بالآية 115 في سورة النساء “وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا”، وبالحديث الصحيح القائل “فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف، كائنًا من كان”. وكان في عبارة “كائنًا من كان” رخصة للجماهير بأن تقاتل الحسينَ، برغم أنَّ جدَّه هو الآمر بذلك.
بعد الإيضاح المفصَّل للسمة الأبرز لسلوك الدولة الدينيَّة، ينتقل الكاتب إلى السمات الأخرى في إيجاز؛ ومنها، عدم إبداء احترام للقدرات الذهنيَّة للبشر؛ ليستمر الجمود الفكري وتُحبط محاولات الإبداع والابتكار؛ ومنها كذلك، تنفير السُّذَّج من الجماهير من دعاة الإصلاح والتنوير، على اعتبار أنَّهم “ليسوا سوى أعداء الله ورسوله” يعيبون في السلطة الدينيَّة لنشر مبادئ هدَّامة (ص189). أضف إلى تلك السمات، عدم قبول النقد أو المعارضة، علاوة على أحاديَّة الرأي وعدم السماح بتعدُّد الأحزاب. تستخدم الحكومة الدينيَّة القمع لإسكات أيِّ صوت يعارض سياساتها أو يفضح أكاذيبها، وبخاصة إذا تعلَّق الأمر بالمطالبة بتحسين الأحوال المعيشيَّة والسعي إلى النهوض باتِّباع العلوم الحديثة. ويضرب الكاتب المثل في ذلك بالحجَّاج بن يوسف، سفَّاح بني ثقيف، الذي قتَّل من بقي من الصحابة والتابعين في زمنه، وحارب كلَّ معارض لسياسة الدولة الأمويَّة، بل ووصل الأمر إلى حصار الحرم المكِّي، وإهدار الدم فيه.
باختصار، يستعرض الكاتب سمات الدولة الدينيَّة محل الانتقاد، موضحًا أنَّها “تلك التي تعتمد على سُلطة مبهمة غامضة، ولا تقوم على أسس دستوريَّة واضحة تحدِّد تبعاتها والتزاماتها حيال الشعب، كما هو شأن الحكومات القوميَّة، والتي تمنح نفسها قداسة زائفة، وعصمة مدَّعاة” (ص196). ويخرج الكاتب، بعد استعراضه سلبيَّات الدولة الدينيَّة التي تفوق أي إيجابيات ممكنة لها، باستنتاج باستحالة إقامة دولة دينيَّة ناجحة. ويوضح الكاتب كذلك الفرق بين مهمَّة كلٍّ من رجل الدين ورجل الدولة؛ فبينما يرعى الأول الفضيلة ويحرث على تحقيق السلام الداخلي، يراقب الثاني تنفيذ القوانين، ويتولَّى إحلال السلام الخارجي. وبما أنَّ وظيفة رجل الدين هي “الوعظ والإرشاد والإقناع”، فمن المستحيل أن يصبح رجل دولة “من حقِّه الإكراه وإنزال العقاب” (ص204). أمَّا عن الحجَّة التي استند الكاتب إليها، فهي قوله تعالى في الآية 256 من سورة البقرة “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ”؛ أي لا يمكن للواعظ أن يحمل السوط أو السيف ويرغم الناس على دخول الدين.
(المصدر: رسالة بوست)